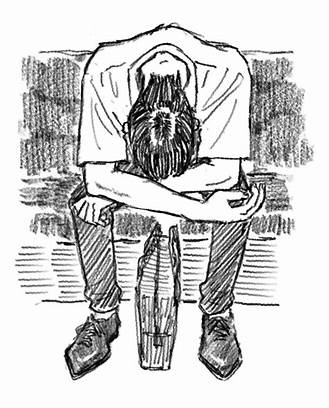الوقاية من المخاطر المهنية المحدقة بالمدرسين/ت…
قبل كل شيء، ينطوي التدريس على مخاطر نفسية متكررة وخطيرة أحيانًا بالنسبة للمُدرسين: فوجود اتصال مباشر ومستمر مع المتعلمين يحتمل أن يكون مصدرًا للسلوك غير المحترم والاعتداء اللفظي أو الجسدي وأعمال التخريب… مما قد يؤدي إلى نشوء مشاعر قوية بالنقص والفشل الشخصي إذا ما واجه المُدرسون باستمرار هذا النوع من الضغوطات والمواقف الصراعية التي تشكك في وضعهم المهني، من خلال الشعور بأن عملهم وهويتهم المهنية يتعرضان للهجوم. وبالإضافة إلى التوقف عن العمل بسبب الاعتداء والضرب، فإن الصدمات النفسية (الاضطرابات النفسية الجسدية، ونوبات الاكتئاب أو القلق، وما إلى ذلك) هي التي تسببها الاعتداءات المنتظمة والمتكررة من هذا النوع.
يجب وضع خطط وقائية لتوقع هذه المخاطر المهنية، سواء كانت جسدية أو نفسية اجتماعية، بدعم من أطباء الوقاية.
تساعد تقنيات الحوار والتواصل على نزع فتيل خطر العنف، ومن بين أكثر الطرق فعالية لإدارة التوتر والنزاع: التدريب على فهم أفضل للآليات التي تلعب دورًا في العلاقة بين المُدرس والتلميذ، وتقنيات “التأقلم” لتحقيق سيطرة انفعالية أفضل في حالات العدوان، والعلاجات السلوكية والمعرفية لمساعدة المُدرسين على إدارة العلاقات المتضاربة مع تلاميذهم أو أولياء أمورهم.
وأخيراً، من الضروري ترسيخ الشعور بالانتماء إلى فريق تدريس يوفر الدعم الاجتماعي، ووضع إجراء لتقديم الدعم والرعاية في حال حدوث عدوان خطير.
يعتبر التعليم قطاعًا واسعًا جدًا، بدءًا من التدريب الأولي للتلاميذ والطلاب إلى التدريب المهني المستمر للكبار، والذي يمكن أن يأخذ في حد ذاته أشكالًا متعددة، يُعتبر التعليم الإلكتروني أحدثَها. يركز هذا الملف على التدريب الأولي التقليدي – فصل دراسي ومُدرس يلقي محاضرة على الأطفال أو المراهقين – وهو إلى حد بعيد أكبر مصدر للوظائف التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية.
السياق الاجتماعي والنفسي لمهنة التعليم
يتم التدريس في بيئة اجتماعية وتقنية تتغير باستمرار وبسرعة، كما أن قدرة المدرسة على توقع وتكييف أهدافها وتنظيمها وأساليب التدريس فيها متواضعة، مما يؤدي إلى العديد من الأعطال التي تترتب عليها عواقب تدهور ظروف عمل المُدرسين.
لقد أُطلِقَ العديد من الإصلاحات الجزئية والعامة دون معالجة الأسباب المنهجية والتنظيمية الكامنة وراءها، وبفائض يؤدي حتماً إلى تشبع قدرة المُدرسين على استيعاب المخططات الجديدة المقترحة مع عدم التكيف مع الواقع المحلي، مما يؤدي إلى نسبة فشل عالية في تنفيذها الفعال، مع فقدان المصداقية من جانب القادة وتدهور المناخ التنظيمي الذي يؤثر على مشاركة المُدرسين الفعالة في مهمتهم.
* تؤثر الاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية الكبرى على ظروف عمل المُدرسين:
– وفي صورة كاريكاتورية، يولد الأطفال اليوم وفي مهدهم جهاز تحكم عن بعد وشاشة في مهدهم، فهم جيل “زابرس zappeurs”، والمحاضرة التي تلقى عليهم وهم في وضعية الجلوس وبقليل من التفاعلية يصعب على كثير منهم تحملها، ويصبحون هائجين وغير متفاعلين ومتبلدين أمام مُدرس يملهيم ويجد نفسه في منافسة مع مجموعة كبيرة من الوسائط الترفيه المتنوعة لنقل المعرفة والوسائل التقنية للحفظ والحساب والتوثيق… والأكثر من ذلك، من المستحيل استخدام استبداد أساتذة ومُدرسي الأمس لكسب الاحترام.
– فالعنف المنزلي المتزايد، وألعاب الفيديو الوحشية والأفلام التي يشاهدها الأطفال بانتظام على شاشات التلفزيون، تولد سلوكًا لا واعٍ في الفصل أو الملعب عن طريق التقليد، وإعادة إنتاج نفس الإيماءات أو الإهانات العدوانية تجاه زملاء الدراسة أو المُدرسين.
– تؤدي صعوبة أو استحالة تشكيل مجموعات متجانسة على أساس الاحتياجات والمستويات الفردية إلى مشاكل في إيقاعات التعلم، مما يولد عدم الفهم والتخلي من جانب بعض التلاميذ، الذين يصبحون عنيفين في التعويض عن ذلك.
– تخلق البيئة المهنية، في الضواحي الصعبة، مع وجود العديد من الأطفال من خلفيات اجتماعية أو عرقية متنوعة للغاية، وأحيانًا في صعوبات مالية أو نفسية كبيرة، حاجة إلى معرفة التنوع الثقافي والتكيف الدقيق معه، خاصة بين المُدرسين الشباب المؤهلين حديثًا الذين يفتقرون إلى النضج المهني. وفي حالة عدم القيام بذلك، هناك خطر كبير من العنف مع التلاميذ أو أولياء الأمور.
– هناك توقعات غير متناسبة من جانب الأسر في ما يتعلق بالمدرسة التي من المفترض أن يوفر التدريس فيها مكانًة مستقبليًة في المجتمع، والآباء الذين غالبًا ما يكونون غير معنيين و/ أو ناقدين، مما يؤدي إلى مواجهة المُدرسين لمتطلبات أكثر تنوعًا وتعقيدًا في ممارسة مهنتهم.
– يمكن أن يكون الآباء عنيفين أو يصبحوا عنيفين في بعض المواقف (تقييم أبنائهم، العقوبات، إلخ)، خاصة في التعليم الوطني الذي هو (كغيره من الخدمات العامة) محور كل الاستياء والإحباط الاجتماعي الذي يلوم فيه بعضُ المواطنين الدولةَ والمجتمع.
– يؤدي انعدام الاستقلالية والمسؤولية التي تتمتع بها الإدارة المدرسية في نظام التعليم الوطني إلى علاقات هرمية غير محفزة للغاية، وغالبًا ما تركز فقط على الإدارة والسيطرة، مع وجود أنظمة تفتيش قديمة يُنظر إليها على أنها غير فعالة ومُستضعفة.
* يؤدي هذا السياق إلى عوامل ضغط متعددة تولد مخاطر نفسية واجتماعية كبيرة:
– ينجم ضعف التحفيز عن عدم ثقة المُدرسين في قدرتهم على القيام بمهمتهم التعليمية والتربوية (الشعور بعدم الفعالية الشخصية وتدني احترام الذات)؛ والشعور بعدم الإنجاز والاعتراف من رؤسائهم. والنتيجة هي الشعور بعدم الكفاءة والشك في قيمة عملهم.
– ومن ثم يشعر بعض المدرسين بأنهم يقومون بعمل عديم الفائدة (يظل التلاميذ متواضعين وغير مهتمين ومزعجين وعدوانيين)، وهو ما يمثل عائقًا نفسيًا كبيرًا وإحباطًا نرجسيًا.
– ويشعر آخرون أنه على الرغم من أنهم لا يزالون يتحملون مسؤوليات كبيرة في تعليم الجيل الأصغر سناً، إلا أنهم لا يتمتعون بأي سلطة أو سلطة اتخاذ القرار أو السيطرة على عملهم، وبالتالي لا توجد فرصة للاستفادة الفعالة من مهاراتهم أو مواهبهم الشخصية. وبالتالي، فإن عدم القدرة على تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية يقوض احترام المُدرس لذاته، كما أن الشعور بالتقليل من قيمة المُدرس هو عامل ضغط محتمل قوي. يُعتبر تحمل المسؤولية الفردية دون امتلاك الوسائل للقيام بذلك عاملاً رئيسيًا في العدوان النفسي (الشعور بالذنب والخجل).
– تزيد أساليب الإدارة المدرسية غير المناسبة من أزمة الثقة بين المُدرسين، والتي تتجلى في أعراض مختلفة: التوترات العلائقية، وعدم الاستثمار، وخيبة الأمل، والسلوك العدواني التهكمي. إن غياب الأهداف الواضحة والواقعية والمشتركة، وعدم الاعتراف بالعمل المنجز بالفعل (بشكل رئيسي من خلال التقييم والتدرج في الأقدمية)، والافتقار إلى الدعم التربوي أو النفسي، كل ذلك يؤدي إلى عدم الرضا المجهِد.
– إن السلوك الجسدي التهديدي (الضرب بالأيدي أو التدمير المادي أو رمي الأشياء أو البصق أو التدافع، إلخ) أو السلوك اللفظي التخويفي (التهديد أو التجاوزات اللفظية أو السباب أو الشتائم أو لغة الازدراء أو غير ذلك)، أو أعمال العنف المتمثلة في تدمير الممتلكات أو استخدام القوة (على سبيل المثال من قبل التلاميذ أو أولياء الأمور) ، كلها جزء من المشكلة. وتتراوح هذه التصرفات بين عدم احترام المُدرس وسلطته ، والتي تتجلى في سلوك يبدو حميدًا نسبيًا (مواقف ازدراء أو ملاحظات استهزاء أو رفض الانصياع لتعليمات السلامة أو التعليمات التنظيمية)، إلى العنف الصريح (الضرب أو الإصابة بسلاح، إلخ)، مما يتطلب إعلانًا عن وقوع حادث في العمل وربما إجراءات قانونية.
– يمكن أن تؤدي المشاكل النفسية الناجمة عن الإجهاد المستمر إلى سلوك عدائي أو عنيف من جانب المُدرسين تجاه التلاميذ المشاغبين.
المخاطر الجسدية لمهنة التدريس
– تعد اضطرابات الصوت بين المدرسين من الأمراض الحقيقية: فكثيراً ما يصيبهم الإرهاق والتغيرات الصوتية بسبب التعرض الدائم والمطول في بيئة صاخبة، مما يتطلب استخدام الصوت ورفعه باستمرار، مما يؤدي إلى ظهور التقطيع الصوتي المؤقت (انقباضات الصوت) وآلام الحنجرة.
– وغالباً ما تُلاحظ لدى المدرسين أمراض وريدية أو أمراض في الظهر بسبب كثرة الوقوف والدوس أمام السبورة.
– وبالنسبة للمواد المكشوفة (الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة والأرض)، فإن المخاطر الكيميائية (الكلور والأمونيا والأحماض أو القواعد، إلخ) والكهربائية والبيولوجية موجودة بشكل واضح أثناء التجارب المعملية، وكذلك تلك المرتبطة بالأدوات الآلية والمعدات في ورش التدريب المهني.
– تعتبر الخدوش والجروح الناتجة عن الاعتداء الجسدي من الحالات التي يوجد فيها خطر الإصابة بالعدوى.
– تشمل الحوادث المحتملة الأخرى السقوط من منصة الفصل الدراسي، والتي يمكن أن تسبب الالتواءات والإجهاد، وردود الفعل التحسسية تجاه الطباشير، والمخاطر المتعلقة بالرياضة لمُدرسي التربية البدنية.
المخاطر النفسية لمهنة التدريس
بالنسبة للمُدرسين، يتأكد الواقع المتزايد للضرر النفسي المرتبط بالضغط النفسي وآثاره الجسدية (أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العضلية الهيكلية واضطرابات الجهاز الهضمي والقلق والاكتئاب وغيرها)، وكذلك أمراض ما بعد الصدمة الناتجة عن زيادة العدوانية.
تنطوي الاستجابة النفسية للبيئة المجهدة على رد فعل هرموني وجسدي: يتم تعبئة نظام الغدد الصماء في مواجهة هذا العدوان أو التهديد، مما يؤدي على المدى القصير والطويل إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وإفراز الكورتيزول والكاتيكولامينات (بما في ذلك الأدرينالين) وما إلى ذلك، مع التأثير على الاستقلاب/التقويض، مما يؤدي إلى العديد من العواقب النفسية الجسدية والاضطرابات الهرمونية.
تتمثل التأثيرات الرئيسية على المُدرسين فيما يلي:
* الأضرار الجسدية
– الاضطرابات العضلية الهيكلية (آلام المفاصل والعضلات)؛
– اضطرابات الجهاز الهضمي (آلام وآلام المعدة والقرحة)؛
– حوادث القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية (ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب وأمراض القلب التاجية وغيرها)؛
– الصداع والصداع النصفي.
* الاضطرابات النفسية
– التعب المزمن والتهيج؛
– اضطرابات النوم؛
– نوبات القلق؛
– متلازمة الاكتئاب.
* الاضطرابات السلوكية
– ردود الفعل العدوانية الذاتية والمغايرة؛
– اضطرابات الأكل (السمنة)؛
– زيادة استهلاك الكحول والتبغ والأدوية (مزيلات القلق) والمؤثرات العقلية؛
– السلوك الخطر والأفعال الانتحاري؛
– اللامبالاة والافتقار التام للدوافع؛
تدابير الوقاية من المخاطر في مهنة التدريس
* تقييم المخاطر المهنية
عندما يتعلق الأمر بالتدابير الوقائية، من الضروري دائمًا أخذ الوضع بأكمله في الاعتبار والعمل على جميع عوامل الخطر.
هذا هو السبب في أن البحث عن التدابير الوقائية يبدأ بتحليل مسبق وتحديد المخاطر المهنية في المؤسسة، والذي يجب أن يتم بطريقة تشاركية وأن ينتج عنه ”وثيقة واحدة“ لتقييم المخاطر المهنية وبرنامج الوقاية السنوي.
من الضروري عدم تبني موقف الإنكار (القمع الجماعي للخطر) أو التبسيط (إنكار تعقيد البيئة والاكتفاء بتدابير تقييدية أو غير ذات جدوى). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نحاول ترشيد التحليل للحد من الشحنة العاطفية و/أو الانفعالية التي ينقلها مفهوم العنف، مما يساهم في تشويش الفهم المتبادل.
يتمثل النهج المتبع في تحليل أعراض المعاناة في مكان العمل بشكل خاص في الانتباه إلى جميع علامات الخطر من خلال تحديد مؤشرات الإنذار المبكر التي تمكن من اتخاذ إجراءات قبل فوات الأوان: قياس الزيادة في تواتر وخطورة حوادث النزاع وأعمال العنف، وتفاقم المؤشرات الصحية السلبية (اضطرابات القلب والأوعية الدموية أو اضطرابات القلق والاكتئاب، إلخ)، وارتفاع نسبة التغيب عن العمل، وما إلى ذلك.
* تدابير الوقاية التنظيمية
غالباً ما يكون التعامل مع الأسباب التنظيمية عاملاً حاسماً في الوقاية من المخاطر النفسية.
وتُعَد الجودة الإدارية في العلاقات الهرمية وعلاقات السلطة والتواصل بما يتماشى مع احتياجات المُدرسين وتوقعاتهم عواملا مضادة للتوتر.
إن الافتقار إلى الدعم أو التماهي مع المجموعة، والأشكال السلبية للقيادة (ضوابط غير مناسبة، وأهداف غير موجودة أو غير واضحة أو مفروضة)، وهياكل التشاور غير الملائمة ونقص التدريب المناسب هي عوامل ضغط رئيسية.
– أولاً وقبل كل شيء، في المدارس التي يمكن فيها اختيار المرشحين، يجب أن يهدف التوظيف إلى اختيار أشخاص يتمتعون بتوازن شخصي قوي: فالبعد العاطفي في المُدرسين، حيث العلاقات الإنسانية جزء من نشاطهم المهني بقدر ما هو جزء من نقل المعرفة، يعني أنه لا ينبغي قبول طلبات الأشخاص المنطوين على أنفسهم والذين يفتقرون إلى مهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الاستماع والتعبير اللفظي والجسدي. إن هشاشة الفرد هي أحد عناصر الخطر المرتبطة بالتوتر العلائقي: من الأفضل للطلاب الذين يرغبون في أن يصبحوا مُدرسين اختبار قدرتهم على إدارة التوترات في العلاقات مع الأطفال أو المراهقين من خلال القيام بعمل كمراقب في المخيمات أو نوادي العطلات أو الرياضة…
– يجري تحفيز الفرد أو المجموعة عندما تُحدَّد أهداف واضحة وواقعية ومشتركة ويتم تقديم تغذية راجعة مناسبة حول قدرة المُدرس على تحقيقها وحول المساعدة التي يمكن تقديمها: يجب أن يكون تحديد الأهداف نتيجة حوار يأخذ في الاعتبار بشكل خاص القيود الخارجية للبيئة الاجتماعية ويتم تحديدها على أساس العناصر التي تقع تحت مسؤولية المُدرس الفعلية. عندها يشعر المُدرسون بأن عملهم يحظى بالتقدير والفهم والتقدير. من المهم التركيز على النتائج الملموسة، حتى وإن كانت محدودة النطاق (”الانتصارات الصغيرة“)، على فترات منتظمة من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الالتزام والرضا.
– إن مفهوم الدعم الاجتماعي – المساعدة الفنية والعاطفية التي يقدمها الزملاء والرؤساء في تنفيذ المهام ودرجة الاندماج في المجموعة والتماسك الاجتماعي – هو عامل قوي في تخفيف آثار التوتر في العمل، بقدر ما يخفف من التوترات المهنية من خلال تخفيفها ومشاركتها وتوفير حلول تستند إلى تجارب الآخرين. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق:
+ من خلال مشروع مدرسي، وهو نتاج عملية تستهدف أعضاء هيئة التدريس، ويهدف إلى تحفيزهم وضمان تماسكهم وتعبئة طاقات الجميع نحو هدف مشترك: يصف المشروع المهمة التي حددتها المدرسة لنفسها ويحدد خطة العمل التي ستنفذها لتحقيقها. الهدف من مشروع المدرسة هو توفير رؤية وتوجيه العمل، من خلال توحيد أعضاء هيئة التدريس وإلهام الرغبة في العمل معًا بطريقة متماسكة وتشاركية وتعاونية. يجب أن يكون قائد المشروع قد تلقى التدريب المناسب في إدارة المشروع.
+ من خلال مجموعات المناقشة مع الإدارة لتدبير الضغوط: للخروج من عزلتهم، يحتاج المُدرسون إلى دعم كبير في عملهم: اجتماعات تشاورية منتظمة للتعبير عن المشاكل المهنية لزملائهم ومناقشة كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجههم، ووضع إجراءات للتغذية الراجعة لتحديد المشاكل ومناقشة الحلول الممكنة، والمساعدة في الوقاية من المخاطر النفسية، وتقديم الدعم في حل المشاكل اليومية مع التلاميذ أو أولياء الأمور. إن المُدرسين الذين عبروا عن المشاكل التي يواجهونها وتوصلوا إلى حلول مقترحة لها يطلقون ديناميكية يمكن أن تؤدي إلى عملية تحسين دائمة إذا ما تمت إدارتها بشكل جيد.
هناك تقنيات تيسيرية مختلفة، حيث يجب أن يكون المشاركون متطوعين ومتخصصين في إدارة الموارد البشرية، مما يتيح مراعاة العوامل النفسية والاجتماعية بكفاءة.
* تدابير التدريب على إدارة الإجهاد
من مرحلة التدريب الأولي فصاعدًا، سيكون من المستحسن تطوير المهارات في مجال التواصل وإدارة النزاعات، من أجل فهم أفضل للآليات التي تلعب دورًا في العلاقة بين المُدرس والتلميذ (مثل تقنيات التواصل اللاعنفي)، لتعلم كيفية إيجاد المسافة الصحيحة من التلاميذ، والمزيج الصحيح من اللطف والصرامة، والانضباط والانفتاح.
إن التدريب الجاد أثناء الخدمة، الذي يتكيف مع الجوانب النفسية لمهنة التدريس، ضروري: في هذا المجال، يكون التعلم أثناء العمل دائمًا عشوائيًا وغير مكتمل.
يتم توفير التدريب في مجال إدارة النزاعات والضغوطات (تقنيات ”التأقلم“ لتحقيق تحكم انفعالي أفضل) من قبل استشاريين متخصصين. ويتمثل مبدأ التأقلم في أن الفرد الذي يواجه موقفًا تصادميًا لديه موارد يمكن استخدامها على أفضل وجه: التقليل من تأثير عامل الضغط أو تجنب المواجهة المباشرة مع عامل الضغط عندما يعتبر الموقف غير قابل للسيطرة عليه. وتكون استراتيجيات التأقلم فعالة لأن الفرد يتعلم في نهاية المطاف التعود على نفس الموقف المثير للضغط النفسي، وتتضاءل تعبيراته عن القلق. هذا التمكن من المواقف المثيرة للقلق يزيل تدريجياً التوتر والمعاناة التي يعاني منها المُدرس، وذلك من خلال تزويده بالوسائل التي تقوي مقاومته الانفعالية والنفسية للعدوانية.
* التدابير الوقائية الفردية
– المراقبة الطبية
بالإضافة إلى الفحوصات التقليدية المتعلقة بحدة البصر ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والوزن، ينبغي اتخاذ إجراءات في الفحوصات الطبية من قبل طبيب الوقاية لاكتشاف الاضطرابات المرتبطة بالتوتر في وقت مبكر، وإحالة المُدرسين إلى الدعم النفسي إذا لزم الأمر، عن طريق شبكات الاستماع والتدخل للمُدرسين الذين يواجهون حوادث أو في مواقف نفسية صعبة، أو عن طريق الممارسة المنتظمة لتقنيات العقل والجسم مثل الاسترخاء أو علم النفس.
– معدات الحماية الشخصية:
تزويد مُدرسي المواد التجريبية والمهنية بمعدات الحماية الشخصية التي تتكيف مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الأدوات أو الآلات المختبرية أو الورش أو الآلات (حماية الجهاز التنفسي، والقفازات، والنظارات الواقية، والملابس، وأحذية السلامة، وما إلى ذلك).
– رعاية المُدرسين الذين وقعوا ضحية اعتداء عنيف:
يجب أن يكون هناك إجراء لتقديم الدعم والرعاية (النفسية والقانونية) للضحايا، من أجل الحد من العواقب النفسية لأمراض ما بعد الصدمة الناتجة عن الهجوم، مثل “استخلاص المعلومات”، أو مقابلة استماع فردية تجرى مباشرة بعد الاعتداء لاسترجاع الحدث بكل تفاصيله وكل ما ولده على المستوى الذهني (العواطف والأفكار والمشاعر المتنوعة والقوية).
– مساعدة الضحايا أثناء استجواب الشرطة:
المتابعة من قبل الأخصائيين النفسيين أو الأطباء النفسيين، بالاشتراك مع الأطباء المهنيين المدربين على هذا النوع من التدخل.
* تدابير الوقاية التقنية
– يجب أن تتوافر في أماكن العمل ظروف صوتية وإضاءة وتكييف هواء مُرضية: على وجه الخصوص، يجب أن تكون جدران وأسقف الغرف مصنوعة من مواد ممتصة للضوضاء، خاصة في قاعات الطعام.
– تركيب أنظمة تهوية فعالة لإزالة الأبخرة والغازات والغبار وما إلى ذلك من المختبرات والورش.
– تصميم المباني وتخطيطها وفقًا لمخاطر الاعتداء: التحكم في الدخول، وتركيب أقفال الدخول، وتركيب أجهزة المراقبة بالفيديو أو الراديو، وأنظمة الإنذار والتحذير، إلخ.
أغسطس 2011
المصدر : https://www.officiel-prevention.com/dossier/formation/fiches-metier/la-prevention-des-risques-professionnels-des-enseignants#:~:text=L’enseignement%20pr%C3%A9sente%20surtout%20des,des%20actes%20de%20vandalisme%20…
اقرأ أيضا